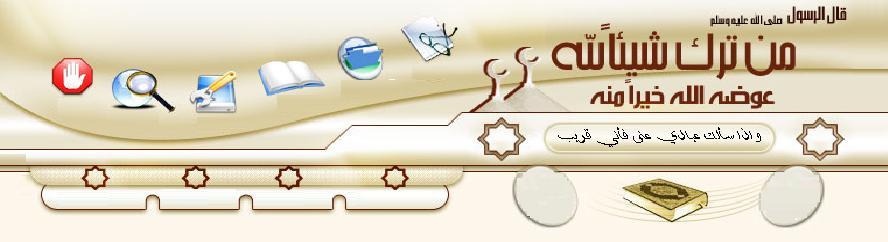الحكام العرب سابت مفاصلهم بعد انتصار الثورة الشعبية التونسية، والهروب
الذليل للديكتاتور زين العابدين بن علي، وزوجته الامبراطورة ليلى
الطرابلسية، التي ابتلعت مع أسرتها وأسرة زوجها جانبا كبيرا من مقدرات تونس
ومواردها، أكلوا لحم البلد الحي، واعتبروا ازدهار أحوالهم علامة على
ازدهار تونس.
جرى ما جرى في تونس، وانتصرت الانتفاضة التونسية، ولاتزال
تواصل معاركها في الشارع ضد ما تبقى من النظام الديكتاتوري المملوكي
الناهب، حدث الزلزال في تونس، والعين على مصر، ربما لأن النظام التونسي
البائد كان صورة طبق الأصل من النظام المصري، ديكتاتورية عائلية معلقة في
القصر الرئاسي المترف، ومن حولها 'جماعة بيزنس' تضخمت ثرواتها الحرام
لأرقام فلكية، ومن تحتها خازوق أمني متضخم ومتورم.
سياسة للنهب العام
تستند الى عصا الكبت العام، واقتصاد ريعى هش تتأتى موارده من معدلات
السياحة المرتفعة في تونس، ومن عوائد عمل التونسيين في الخارج، وهي مثل
موارد الخزانة العامة في مصر، يضاف إليها عوائد ورسوم الملاحة في قناة
السويس، وبعض عوائد بيع البترول والغاز، وفي الحالتين ـ تونس ومصر ـ جرى
تحطيم وتجريف القواعد الانتاجية الكبرى، وفي المحصلة بدا دور النظام
التونسي نسخة طبق الأصل من دور النظام المصري، في الحالتين بدا الولاء
لأمريكا والاستعداد لخدمة إسرائيل فرضا لا سنة، وفي بنية النظام السياسي،
بدا التماهي ظاهرا إلى حد التطابق، مع فارق لمبارك مصر الذي ظل في الحكم
ثلاثين سنة إلى الآن، بينما انتهت سيرة بن على عند حاجز الثلاثة والعشرين
خريفا، واستنادا إلى حزب إداري ينتهي اسمه، في الحالين، بلفظة 'الديمقراطي'
على سبيل النكاية، واصطناع أحزاب معارضة صورية بديلا عن المعارضات
الحقيقية، والاحتفاظ بها كديكور يتآكل خداعه مع تقادم الزمن، وافتعال 'كوتة
للمرأة' سبق إليها النظام المصري قبل تولي زين العابدين بن علي في تونس،
ثم عدل عنها النظام المصري، فلجأ إليها النظام التونسي، ثم أعاد النظام
المصري الكرة تقليدا لنظام تونس المخلوع هذه المرة، وبانتخابات تخلو بالمرة
من أبسط معاني الانتخابات، وتمتاز بالتزوير الشامل الكامل لصالح رجال
ونساء مختارين بعناية العائلة وحراسة الأمن، وبتحصين كرسي الرئاسة من
التبديل والتغيير، بوضع شروط مانعة جامعة قابضة للروح، واشتراط الإتيان
بلبن العصفور لمن يرغب في الترشح الجاد، ففي تونس الأصغر كان الشرط هو
الحصول على تواقيع ثلاثين نائبا وثلاثين والي مدينة، مع العلم أن هؤلاء
جميعا من حزب الرئيس، من حزب التجمع الدستوري 'الديمقراطي' الحاكم، وفي مصر
الأكبر بدا الشرط أكثر غلظة وأكثر استحالة، وهو الحصول على تواقيع 65 عضوا
من مجلس الشعب و45 عضوا من مجلس الشورى، و140 عضوا من مجالس المحليات في
عشر محافظات، مع العلم أن كل هؤلاء من الحزب الوطني 'الديمقراطي' الحاكم،
إنه التطابق المثير للدهشة، حتى في أدوار الرئيس وزوجته، ربما مع فارق أن
النجل جمال مبارك في قلب الصورة المصرية، بينما أبناء زين العابدين الذكور
لا يزالون صغارا، فتمدد دور الزوجة ليلى، وكان مزاد التوريث محجوزا للسيدة
الفاتنة، التي بدأت حياتها 'كوافيرة'، وانتهت مليارديرة هاربة.
هذا
التطابق بين النظام التونسي، الذي تنخلع قوائمه الآن بعد أن طار رأسه، وبين
النظام المصري الذي يقيم رئيسه غالبا في شرم الشيخ، بعيدا عن قلق ومواجع
الكتلة السكانية الغالبة في وادي النيل، يثير سؤالا ملحا عن تطابق مقابل،
عن احتمال تطابق ثورة متوقعة في مصر مع الثورة التونسية، والسؤال في محله
تماما، رغم تفاوت في التفاصيل على جبهة المعارضة وأشواق التغيير بالذات،
فالمعارضة التونسية الجدية بدت مهاجرة في غالبها ولاجئة للخارج، بينما
المعارضة المصرية الجدية تقيم غالبا في الداخل، وباستثناء ظاهرة محمد
البرادعي المقيم غالبا في طائرة، أو في قصره الأنيق على طريق القاهرة ـ
الإسكندرية الصحراوي، ورغم تطابق بنية القمع، وزيادة معدلات الاعتقال
والاختفاء القسرى والتعذيب حتى الموت فى مصر، فقد تولد هامش من حريات
التعبير والتنظيم والحركة خلافا لأوضاع تونس زين العابدين، وهو فارق يبدو
لصالح المعارضة المصرية في القراءة الظاهرة، لكن المحصلة لم تكن كذلك، فقد
أدى الهامش الرجراج إلى قدر من 'رخاوة عضلات المعارضة' إن صح التعبير، ثم
أن الهامش تقلص باطراد في العشرين شهرا الأخيرة بالذات، اضافة الى أن
الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية في مصر أكثر سوءا بما لا يقاس مع أوضاع تونس
بن علي، فمعدلات الفقر والعنوسة أكبر في مصر، ومعدلات المرض صاروخية
الطابع، فمصر رقم (1) في معدل الاصابة بالفشل الكلوي، ومصر رقم (1) في
التهاب الكبد الوبائي السرطاني على صعيد الدنيا كلها، ومصر رقم (1) في نزيف
الأسفلت والموت بحوادث الطرق، وفي مصر أغنى طبقة في المنطقة العربية،
وأفقر شعب على الإطلاق، وربما لذلك بدت ظواهر التقليد المصري لتكتيك الثورة
التونسية، خافتة إلى الآن في السياسة، وظاهرة جدا على الصعيد الاجتماعي،
فقد بدت مشاهد الانتحار بإشعال النار علنا في شارع عام أكثر تواترا في مصر،
وعلى طريقة محمد البوعزيزي ـ شهيد سيدي بو زيد ـ الذي افتتح باسمه الجليل
واحدة من أعظم انتفاضات التاريخ .
ماذا يعني ذلك؟ ربما يعني أن انتفاضة
محتملة في مصر قد تماثل انتفاضة تونس في المعنى العام، ولكن مع اختلاف في
التفاصيل، فقد بدت الثورة التونسية طاغية التأثير على مزاج الجمهور المصري،
وتدافعت موجات هائلة من النكات المتداولة على طريقة المصريين، كلها تسخر
مما تسميه عجز المصريين مقابل شجاعة التونسيين، وفي صورة نقد ذاتي جماعي
تلقائي سوف يكون لها أثرها، خاصة أن الثورات في هذا العصر ـ تماما كالحروب ـ
يجري نقلها بالصورة النافذة للعين والقلب والعقل والضمير والوجدان، بينما
في دروس السياسة تبدو عظات الثورة التونسية بليغة ناطقة، ولعل أهمها درسان،
الدرس الأول في تلاحقات ما جرى تونسيا، فقد تحول الغضب الاجتماعي المفرق
بسرعة إلى غضب سياسي شامل، وهو درس بالغ الأهمية لطلائع المصريين، فقد
دعونا، قبل 'انتفاضة المحلة' في 6 نيسان/أبريل 2008، إلى مزج الغضب
الاجتماعي بالغضب السياسي، وظواهر الغضب الاجتماعي هائلة جدا في مصر، فخلال
السنوات الثلاث الأخيرة فقط، تدافع إلى المشهد المصري ما يزيد عن خمسة
آلاف مظاهرة واعتصام وإضراب اجتماعي، شارك فيها مئات الآلاف من المصريين،
ولكن بدون ربط وثيق بأولوية التغيير السياسي، فيما بدت معه الصورة مبتسرة،
مبشرة ومحبطة معا، قلقة وموزعة الألوان ومشوشة البريق، وبدون رسم لوحة
متكاملة لثورة شعبية حقيقية، غضب يطفو ويخبو، ولا يقلع بالجملة من محطات
اليأس المقيم، فقد زادت رقعة الأمل، وزادت رقعة اليأس الانتحاري أيضا، وبدت
مصر كأنها في جحيم اجتماعي صامت إلى جوار الغضب الاجتماعي الناطق، ويكفي
أن نعلم ما جرى في عام واحد طبقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة
والإحصاء، فقد أقدم 180 ألف شاب مصري على محاولة الانتحار في عام واحد
(2009)، وانتهت المحاولات إلى مفارقة الحياة في خمسة آلاف حالة، بينما جرى
إنقاذ الباقين في آخر لحظة، الدرس الثاني للثورة التونسية يبدو ملهما أكثر،
فقد تحررت تونس بتحرك العشرات والمئات فالآلاف، ثم إلى ما لا يزيد عن
عشرين ألفا في مظاهرة التتويج أمام مبنى وزارة الداخلية في العاصمة تونس،
وهو ما يعني أن تغيير النظم الديكتاتورية المملوكية لا يحتاج لحركة
الملايين، وعلى نحو ما تروج له 'فرق المرجئة' السياسية، فقط يحتاج التغيير
إلى حركة الآلاف الجسورة المصممة على اجتياح حواجز الخوف، ولسبب جوهري،
فالنظم الديكتاتورية المملوكية تبدو معلقة، وبلا قواعد ارتكاز اجتماعية ولا
سياسية، وتلك ثغرة الضعف الكبرى في بنية هذه النظم، وهو ما يعني بالقياس
إلى تفاوت الحجم السكاني بين مصر وتونس، أن تحريك مئتي ألف أو حتى مئة ألف
مصري كاف جدا لإطاحة نظام مبارك، وقد كنا في حركة كفاية أول من دعا ـ قبل
سنوات ـ إلى تحرك شعبي ينتهي بمظاهرة المئة ألف، وبعصيان مدني يمزج الغضب
الاجتماعي بالغضب السياسي، ثم أضفنا تصورا مفصلا لمرحلة انتقالية تلي نهاية
حكم العائلة، وهو التصور الذي تتوافر ممكناته في مصر أكثر من حالة تونس،
ويعصم البلد من مخاطر الفراغ والفوضى .
وبالجملة، بدت ثورة تونس
العبقرية تلقائية جدا، وبجمهور بلا قادة، بينما المشهد المصري مزدحم
بالقادة، وبمقدرة غير كافية لاستدعاء الجمهور لانتفاضة شارع، وربما تحتاج
مصر، الآن، إلى مخاطرة محمد البوعزيزي لا إلى تردد محمد البرادعي.