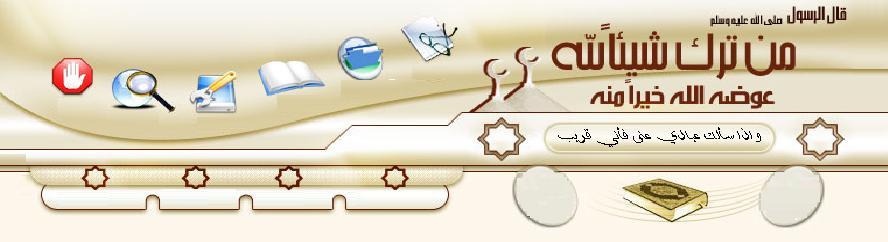أثير فى الفترة الأخيرة جدال على صفحات الصحف حول توصيف الحقبة العثمانية فى تاريخنا، ووصف ما حدث سنة 1517 عندما دخل سليم الأول مصر، هل نسمى هذا فتحا أم غزوا؟ وكان ذلك بمناسبة التعديلات التى دخلت على الكتب الدراسية فى الصف الثالث السنوى، واستخدام مصطلح الغزو العثمانى بدلا من الفتح العثمانى. وانقسم المشاركون فى هذا الجدل بين مؤيد للتعديل باعتبار أن الدولة العثمانية دولة أجنبية غزت مصر، ومعارض يعتبر أن الدولة العثمانية دولة إسلامية وأن ما قامت به يعد فتحا وليس غزوا، وأساس هذا الجدل أن مصطلح الغزو يحمل دلالات سلبية بينما يحمل مصطلح الفتح دلالات إيجابية. وهذا الموقف من المصطلحين يرتبط بوعينا وإدراكنا اليوم، فالقدماء لم يحملوا أيا من المصطلحين بدلالات سلبية، فمعارك المسلمين فى العهد النبوى كانت توصف بالغزوات، حتى فتح مكة تصفه كثيرا من المصادر الإسلامية القديمة بغزوة فتح مكة، وسلاطين العثمانيين أنفسهم كانوا يحملون من بين ألقابهم لقب الغازى، إذا لم تكن للمصطلح أى دلالة سلبية فى العصور السابقة، وقد اكتسب المصطلح دلالاته السلبية فى عصرنا الراهن، ولأننا الآن أصبحنا مختلفين حول ما فعله العثمانيون بمصر، هل كان حدثا سلبيا أم إيجابيا؟ فقد أصبحنا مختلفين حول استخدام المصطلحين «الغزو» أم «الفتح» بعد تحميلهما بالدلالات المعاصرة الآن. فمن يرى فى دخول العثمانيين مصر حدثا سلبيا يستخدم مصطلح غزو، ومن يراه حدثا إيجابيا يستخدم مصطلح فتح.
فهناك اتجاهان أساسيان فى النظر إلى الموضوع، اتجاه يرى أن ما حدث كان احتلالا أجنبيا للمنطقة العربية أضعفها وأدى إلى تدهور أوضاعها وانتهى باحتلال القوى الاستعمارية الغربية لها، واتجاه ثان يراه مجرد تبدل فى الأسر الحاكمة الإسلامية، حيث حل العثمانيون محل المماليك، مثلما حلت الدولة العباسية من قبل محل الدولة الأموية، ويرى أن الدولة العثمانية الفتية قد حمت المنطقة من التوسع الاستعمارى الغربى لقرون.
لكن للمسألة العثمانية فى تاريخنا أبعادا أعمق من مجرد استخدام المصطلحات.
لقد ساد لسنوات طوال اتجاه بين المؤرخين المتخصصين فى العصر العثمانى يسم ذلك العصر بأنه عصر للجمود والتدهور، فقد كان من المسلم به بين الباحثين المتخصصين، وكذلك بين المثقفين بشكل عام، أن الحكم العثمانى للمنطقة العربية هو المسئول عن تخلفها عن ركب التقدم، وهو الذى أدى إلى عدم تطورها لثلاثة قرون، تمتد من أوائل القرن السادس عشر إلى بدايات القرن التاسع عشر، وهى ذات القرون التى أنجز فيها الغرب نهضته الحديثة، وإذا كانت هذه الأفكار قد وجدت سندها العلمى القادم من الغرب فى كتابات المستشرقين الأوائل الذين درسوا العصر العثمانى، مثلما وجدته فى النظرة الماركسية للتاريخ فى صورتها الكلاسيكية وفى تنويعاتها الجديدة، فقد كان لتيارات الفكر السياسى العربى الحديث ــ خاصة التيار القومى العربى والتيار الليبرالى دورهما فى التهيئة لهذه الأفكار وتحقيق الانتشار الواسع لها، فقد كانا منذ البداية فى صدام ومواجهة مع الدولة العثمانية، بهدف تحقيق الاستقلال عنها من ناحية، وبناء أسس للحداثة على النمط الأوروبى فى مجتمعات منطقتنا العربية من ناحية أخرى، ولما كانت الدولة العثمانية هى صاحبة السيادة الفعلية أو الاسمية على جل العالم العربى إلى العقد الثانى من القرن الماضى، فقد تحملت وزر ما آلت إليه أحوالنا حينذاك.
إلا أن ربع القرن الأخير شهد تحولات مهمة فى النظر إلى العصر العثمانى، فقد أصبحت فترة الاحتلال العثمانى للمنطقة العربية من الفترات المثيرة للجدل بين المشتغلين بالدراسات التاريخية، حيث ظهرت مجموعة من الكتابات الجديدة التى حملت رؤية مختلفة لتاريخ مصر والمنطقة العربية فى العصر العثمانى، رؤية تستقرأ فى ذلك العصر حركة عوضا عن الركود، تطورا بديلا عن التدهور، وصحوة تنفى صفة الجمود عن تلك الحقبة، وكانت دراسة الباحث الأمريكى بيتر جران حول «الجذور الإسلامية للرأسمالية» ــ التى صدرت فى أواخر السبعينيات من القرن الماضى رائدة فى هذا المجال، ومؤسسه لاتجاه جديد فى الدراسات العثمانية.
ومثلما كان للرؤية التقليدية للعصر العثمانى أسسها، كان للاتجاه الجديد أعمدته التى قام عليها، فمن ناحية ازدادت معرفتنا بذلك العصر مع ظهور مصادر تاريخية جديدة مكنتنا من التعرف على المزيد من تفاصيل الحياة فى تلك الحقبة ومن إجراء دراسات علمية عميقة عنها ، وذلك بعد اكتشاف عشرات من المخطوطات التاريخية والأدبية والفقهية التى لم تكن معروفة من قبل، فضلا عن إتاحة آلاف الوثائق والدفاتر المالية والسجلات القضائية ــ التى تزخر بالبيانات الدقيقة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والقانونية ـ للباحثين، نتيجة لفتح خزائن الأرشيف العثمانى والاهتمام بالأرشيفات العربية وتنظيمها وتيسير سبل الاطلاع فيها أمام الباحثين المتخصصين، ومن ناحية أخرى كان لظهور مدرسة نقد الاستشراق واتجاهات ما بعد الحداثة وما بعد الكولونيالية فى الغرب أثر فى توفير الدعم النظرى للمدرسة العثمانية الجديدة، وبعيدا عن تلك المدرسة الجديدة التى تحركت من منطلقات علمية، لا يخلو الأمر من بعد سياسى يرتبط بالصعود الجديد للتيارات الإسلامية فى المنطقة العربية منذ سبعينيات القرن العشرين، والتى سعت دوما لتبرئة ساحة الدولة العثمانية من كل ما نسب إليها من آثام، باعتبارها الامتداد «التاريخى» لدولة الخلافة الإسلامية!
إذا فنحن أمام إشكالية لها أبعادها المتعددة، فهناك القدر المتاح من المعرفة بناء على ما هو متوفر من المصادر، والذى أدى بدوره إلى فرص أكبر للبحث فى فترة تاريخية ظلت متروكة لسنوات، وهناك القراءات المتعددة للمصدر الواحد، تلك القراءات التى تتأثر بالنظريات المختلفة الجديدة فى تفسير التاريخ، ثم يختلط بهذا وذاك البعد السياسى فى القضية.
لكن تبقى أسئلة تحتاج إلى إجابات بعيدا عن خلفيات الصراع النظرى حول العصر العثمانى.
هل اعتبر المصريون المعاصرون للحدث فى القرن السادس عشر العثمانيون غزاه أم اعتبروهم مجرد حكام جدد؟
هل أدت الحقبة العثمانية فى تاريخنا إلى تطور المجتمع المصرى أم إلى تدهوره؟
هل حمت الدولة العثمانية المنطقة من التوسع الاستعمارى الأوروبى أم أضعفتها فأدت إلى سقوطها فريسة سهلة فى أيدى المستعمرين؟